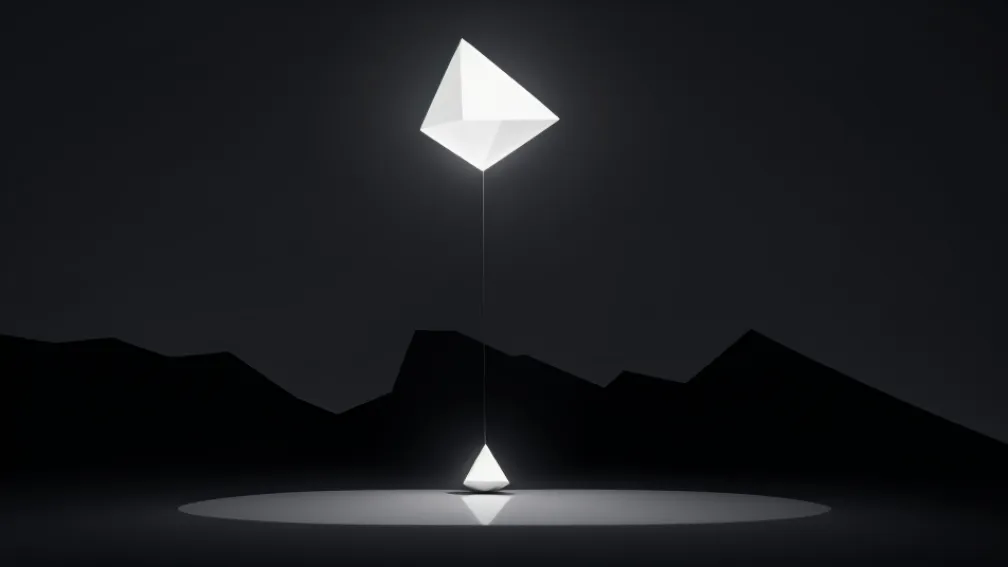
في كلمات قليلة
في دراسة معمقة، يكشف المؤرخ الفرنسي جان جاك مونييه أن المركزية الشديدة التي تميز فرنسا ليست نتاج الثورة الفرنسية، بل هي عملية تاريخية طويلة بدأت مع الملوك الأوائل. يوضح الكتاب كيف أدت هذه السياسة إلى تهميش الأقاليم وقمع ثقافاتها ولغاتها، مما خلق فجوة عميقة مع العاصمة باريس لا تزال قائمة حتى اليوم.
تحت عنوان صادم "باريس هي كل شيء والأقاليم لا شيء"، يقدم المؤرخ والجغرافي الفرنسي جان جاك مونييه تحليلاً تاريخياً عميقاً في كتاب من مجلدين عن مركزية الدولة الفرنسية، كاشفاً عن جذورها التي تمتد إلى ما هو أبعد من الثورة الفرنسية، وتأثيرها المستمر في خلق فجوات وعدم مساواة بين العاصمة والمناطق الأخرى.
خلافاً للاعتقاد الشائع بأن المركزية بدأت مع اليعاقبة أثناء الثورة، يؤكد مونييه أن أصولها تعود إلى أوائل الملوك الكابيتيين، وتحديداً أوغ كابيه. فمن مملكة صغيرة لا تتجاوز مساحتها إدارتين فرنسيتين حاليتين، بدأت عملية توسع عنيفة ومنهجية، حيث أعلن الحاكم نفسه "ملكاً" نافياً هذا اللقب عن الآخرين، مؤسساً لعدم مساواة هيكلية منذ البداية.
يبرز مونييه دور ملوك مثل فيليب أوغست (1170-1223) وفيليب الجميل (1285-1314) كأبرز مهندسي المركزية. فبعد معركة بوفين، لم يضم فيليب أوغست مناطق جديدة فحسب، بل غزا كونتية تولوز، مما غير طبيعة النظام وأدى إلى تراجع حضارة جنوب فرنسا ولغتها الأوكسيتانية المزدهرة. أما فيليب الجميل، فقد حول الدولة الإقطاعية إلى ملكية حديثة تفرض إرادة الملك على الجميع، وهو النموذج الذي أتقنه لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر في القرن السابع عشر لتعزيز الحكم المطلق.
كانت الأساليب المستخدمة في التوسع وحشية، وتضمنت الزواج القسري واستخدام القوة الغاشمة. يصف مونييه "عملية الصعق" التي كانت تهدف إلى إخضاع النخب المحلية عبر ترويع السكان. ويستشهد بأحداث مروعة مثل مذبحة 400 من الكاثار في لافور، وحرق الفلاحين أحياء في كنيسة أرسي، وممارسات عنيفة في بريتاني وغيرها من المناطق. حتى الفيلسوفة سيمون فايل شبهت دخول قوات لويس الرابع عشر إلى ستراسبورغ بانتهاكات هتلر.
ورغم ذلك، كانت الملكية تظهر براغماتية أحياناً، فتمنح بعض الحكم الذاتي للمناطق المقاوِمة مثل الألزاس وبريتاني، معترفة بتعدد اللغات كدليل على اتساع المملكة. لكن الثورة الفرنسية غيرت كل شيء. فبعد إعدام لويس السادس عشر، سعى الثوريون إلى خلق وحدة جديدة تقوم على سلطة مركزية واحدة، ووحدة الأراضي عبر رفض الفيدرالية، ووحدة اللغة عبر السعي لـ"إبادة" اللهجات المحلية، وهو ما أدى إلى استبدال المقاطعات التاريخية بـ 83 "دائرة" مصطنعة لترسيخ مبدأ "فرق تسد".
ويشير مونييه إلى أن هذا النموذج المركزي القمعي استمر تحت كل الأنظمة اللاحقة، من نابليون الذي رسخه، إلى الجمهورية الثالثة التي استخدمت المدارس لفرض اللغة الفرنسية ومعاقبة الأطفال الذين يتحدثون لغاتهم الإقليمية. ويرى أن هذه السياسة تخفي خوفاً من الانفصال، نظراً لأن فرنسا، كملتقى للحضارات اللاتينية والسلتية والجرمانية، لم تكن "دولة طبيعية" بل نتاج إرادة سياسية قوية.
ويخلص المؤرخ إلى أن هذه المركزية غير فعالة اليوم، وتؤدي إلى احتجاجات اجتماعية مثل "السترات الصفراء" و"القلنسوات الحمر"، التي اندلعت بسبب قرارات اتُخذت في باريس دون مراعاة واقع المناطق الأخرى. وفيما يطالب الكثير من الفرنسيين بتدخل أكبر من الدولة، يرى مونييه أن هذا مجرد حلقة مفرغة، وأن الحل يكمن في نظام فيدرالي، كما في سويسرا وألمانيا، يمنح السلطات المحلية صلاحيات حقيقية للتكيف مع احتياجاتها، بدلاً من التمسك بـ"تقاليد" أثبتت عدم جدواها.

